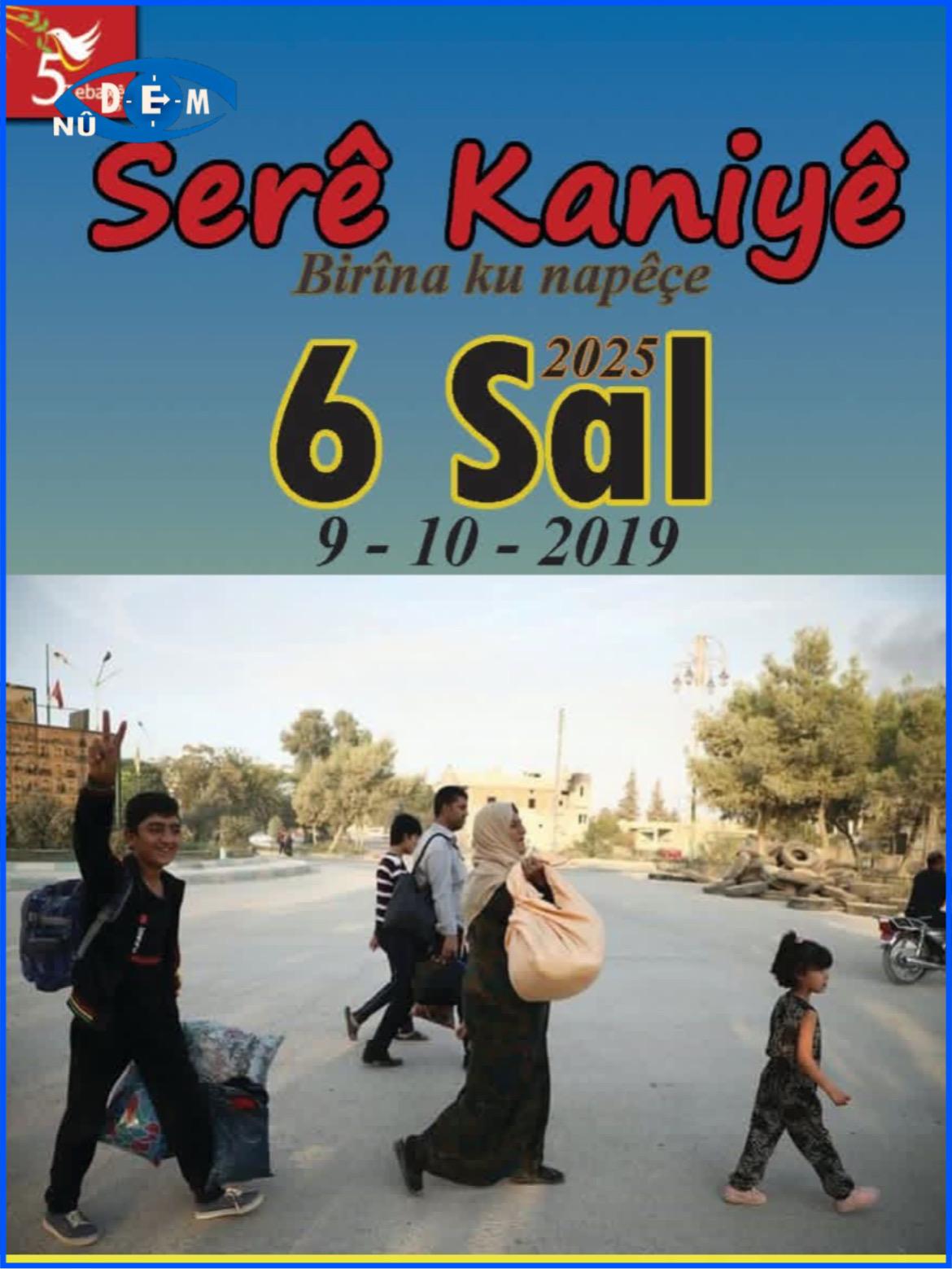الكاتب الصحفي: سالان مصطفى

من الجذور إلى النتائج تحليل شامل لاستفتاء كردستان بين الحق التاريخي والواقع المر
في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017، انطلقت أصوات أكثر من 3 ملايين و305 آلاف كردي وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 72%،
في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وخارج كردستان، في استفتاء تاريخي على الاستقلال كانت نسبة التأييد الساحقة، التي تجاوزت 92%، صرخة مدوية أراد منها الشعب الكردي أن يعلن للعالم أنه لم يعد يقبل بأن يكون ضحية لتاريخ من المظالم والاتفاقيات الدولية التي قسمت أرضه وشرذمت وجوده لم يكن هذا الاستفتاء مجرد حدث سياسي عابر، بل كان تتويجًا لمسار طويل من النضال والتضحيات، واختبارًا حقيقيًا للمواقف الدولية، والإقليمية من حق أقدم شعب في المنطقة بتقرير مصيره.
الجذور التاريخية: تراكم المظالم كأساس للقرار
لم يولد قرار إجراء الاستفتاء من فراغ، بل كان نتيجة حتمية لتراكم تاريخي من القمع والغدر، يمكن تتبعه منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية.
الإرث الاستعماري ووعود ضائعة: مع نهاية الحرب العالمية الأولى، أُحيط الشعب الكردي بشبكة من الاتفاقيات المتناقضة، فبينما وعدت معاهدة سيفر 1920 بإنشاء دولة كردية، جاءت معاهدة لوزان 1923 لتمحو هذا الوعد، مقسمة كردستان بين تركيا والعراق وسوريا وإيران تحت تأثير اتفاقية سايكس بيكو كان هذا التقسيم الثاني لكردستان، وأكبر مظلمة حديثة في الوعي الجمعي الكردي، حيث تم التفريط بمصير أمة بأكملها على مذبح المصالح الاستعمارية.
عصر البعث والإبادة: إذا كان التقسيم هو الجرح، فإن حكم نظام البعث في العراق كان الملح عليه، فقد شنت الحكومات العراقية المتعاقبة سلسلة من الحملات الإبادة ضد الشعب الكردي، بلغت ذروتها في:
(اتفاقية الجزائر 1975) التي توسطت فيها إيران والولايات المتحدة، حيث تنازل صدام حسين عن شط العرب مقابل وقف الدعم الإيراني للأكراد، في صفقة سياسية خيانية كشفت كيف يمكن التضحية بالكرد كأداة للمساومات الإقليمية.
(حملة الأنفال 1988) “التي أودت بحياة ما يقدر بـ 182,000 كردي، ودمرت الآلاف من القرى، وهي أحداث وثقتها منظمات حقوقية دولية”. (Human Rights Watch,1992)
الهجوم الكيماوي على حلبجة (1988): الذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء في دقائق، ليصبح رمزًا للقمع الوحش الذي تعرض له الكرد.
ما بعد صدام: دستور معطل ووعود مجوفة: بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، شارك الكرد في بناء العراق الجديد، وسعوا إلى ضمان حقوقهم عبر الدستور العراقي لعام 2005، الذي اعترف بحكم إقليم كردستان فدرالياً ونص في “المادة 140” على حل مشكلة المناطق المتنازع في إجراء “التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة”. (العلي، 2019). إلا أن الحكومات المركزية في بغداد، بغض النظر عن انتمائها الطائفي، تعمدت تعطيل هذه المادة وغيرها من المواد، مما عمق الشعور الكردي بأن الشراكة في العراق مستحيلة
صعود داعش والتفريط بالأمن القومي العراقي: عندما اجتاح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق عام 2014، تهاوى الجيش العراقي تاركًا المدن ذات الغالبية السنية، ومن ثم الكردية الإيزيدية لمصيرها كانت قوات البيشمركة وبمساندة من قواتYPG هي الخط الدفاعي الأول الذي أوقف زحف التنظيم، ودفع ثمن ذلك آلاف الشهداء، في الدفاع عن الإيزيديين الذين تعرضوا لإبادة جماعية “وكانت قوات كردية قد دخلت البلدة وبدأت في تعقب مسلحي التنظيم، وذلك بعد يوم من بدء هجوم بغية استعادة السيطرة على البلدة”. (معركة سنجار، 2015). في المقابل، “فضلت بغداد الاعتماد على الحشد الشعبي المدعوم من إيران، مما عزز القناعة لدى الكرد أن بغداد لم تعد قادرة أو راغبة في حماية مواطنيها، وأن قرارهم بأيديهم أصبح مسألة حياة أو موت” (Gunter, 2018).
الاستفتاء: الزخم الدولي والتحول المفاجئ
في البداية، بدا أن رياح التاريخ تهب لصالح المشروع الكردي، فقد حظي مبدأ إجراء الاستفتاء بتفهم ودعم، علني أو ضمني، من قبل العديد من الدول الغربية التي رأت في الكرد حليفًا استراتيجيًا في الحرب ضد الإرهاب إلا أن هذه الآمال سرعان ما تبددت مع اقتراب موعد الاقتراع.
الرفض الإقليمي المتضامن: أظهرت الدول الأربع التي تتقاسم كردستان (تركيا، إيران، سوريا، العراق) وحدة غير مسبوقة في رفض الاستفتاء فهم رأوا فيه سابقة خطيرة قد تهدد كياناتهم القومية الهشة، فتحالفات جيوسياسية متشابكة، ومخاوف من “عدوى” الاستقلال تطال الكرد في الأجزاء الأخرى لكردستان، جعلتهم يتفقون على خنق التجربة في مهدها.
التراجع الغربي المخيب للآمال: كان الموقف الأمريكي والأوروبي الأكثر إيلامًا، فبدلاً من دعم حليفهم الذي قاتل إلى جانبهم ضد “داعش”، انحازت هذه الدول لـ “استقرار” العراق والدول المجاورة، فالأولويات الاستراتيجية الغربية، المتمثلة في منع تفكك العراق، والحفاظ على العلاقات مع أنقرة وطهران تغلبت على مبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير التي تدعيها أصدرت الولايات المتحدة تصريحات تلو الأخرى ترفض فيها التوقيت وليس المبدأ، في محاولة لإلقاء اللوم على القيادة الكردية (Gunter, 2018).
الحق الدولي وتقرير المصير: بين النصوص والواقع المرير
يعد حق تقرير المصير من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الحديث، فقد أعلنه الرئيس الأمريكي “وودرو ويلسون” بعد الحرب العالمية الأولى، وأكدته لاحقًا مواثيق الأمم المتحدة تنص المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) على أن “لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي” (United Nations, 1966). كذلك، فإن إعلان الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (القرار 1514) لعام 1960 يؤكد على هذا الحق. (Declaration on the Granting of Independence,” 1960)
إلا أن التطبيق العملي لهذه المبادئ يخضع دائمًا للحسابات الجيوسياسية، فالشعوب التي تناضل من أجل حقها المشروع تواجه بمعيارين: معيار المبدأ المجرد، ومعيار المصالح وفي حالة كردستان تم إخضاع الحق المشروع لاعتبارات “الاستقرار الإقليمي”، وهو ما يشكل تناقضًا صارخًا مع روح القانون الدولي (Natali, 2017).
التكالب الإقليمي والخيانة الداخلية: اختبار الإرادة الكردية
كان رد الفعل الإقليمي على نتائج الاستفتاء أقسى مما توقعه الكثيرون، وكشف عن عمق الخلافات الداخلية الكردية.
الحصار والعقاب الجماعي: فرضت بغداد وأنقرة وطهران حصارًا شاملاً على إقليم كردستان، متضمنًا إغلاق المجالات الجوية والممرات البرية كان الهدف واضحًا خنق الاقتصاد الكردي الناشئ وإجهاد المواطن العادي لإجباره على التخلي عن قراره.
الخيانة من الداخل: في أصعب لحظة، كشفت بعض الأطراف السياسية الكردية عن ولائاتها الحقيقية، فبدلاً من توحيد الصف لمواجهة التحديات، قام “الاتحاد الوطني الكردستاني”، بسحب قوات البيشمركة التابعة له من “كركوك” في أكتوبر 2017، مما مهد الطريق لقوات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيًا للسيطرة على المدينة دون قتال يذكر هذه الخطوة، التي وصفها محللون بأنها “خيانة للقضية الكردية” (Gunter, 2018، ص. 85)، لم تكن فقط تسليمًا لأهم رمز تاريخي واقتصادي للكرد، بل كانت طعنة في ظهر المشروع الوطني.
ثبات بارزاني: قيادة في مواجهة العاصفة: في وجه هذا الضغط الهائل، داخلي وخارجي، ظل الرئيس بارزاني متمسكًا بقرار الشعب لقد رأى أن التراجع يعني إهدار دماء الشهداء وتكريس التبعية لبغداد وطهران.
موقفه هذا كان يعكس إرثًا نضاليًا طويلاً، حيث قاد مسيرة شعب طالب بحقه في الوجود، فقد فهم البارزاني أن الاستفتاء بحد ذاته، بغض النظر عن نتائجه المباشرة، هو إنجاز لأنه حول القضية الكردية من مسألة محلية إلى قضية دولية.
نتائج الاستفتاء ومابعدها: بين النصر المعنوي والتراجع العملي
من الناحية العملية المباشرة، لم يؤد الاستفتاء إلى إعلان دولة مستقلة فقد تراجعت حكومة الإقليم تحت وطأة الحصار والضغوط، واستقال الرئيس بارزاني، ودخل الإقليم في أزمة سياسية واقتصادية طاحنة إلا أن النتائج الاستراتيجية كانت أعمق.
التأكيد على الهوية الوطنية: أثبت الاستفتاء بشكل قاطع أن الغالبية العظمى من الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق يتطلع إلى الاستقلال.
كسر حاجز الخوف: تجرأ الشعب الكردي على التصويت علنيةً لمصلحة الاستقلال، متحديًا كل التهديدات الإقليمية والدولية.
فضح المواقف: كشف الاستفتاء الوجه الحقيقي للدول الإقليمية والدولية، وأظهر أن مصالحها تتقدم على مبادئها.
المفارقة الروسية: في تحول لافت، أعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” من أنقرة دعمه لحق الكرد في تقرير مصيرهم، في خطاب يهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي في المنطقة على حساب الأمريكي هذا الموقف، رغم كونه مدفوعًا بمصالح روسيا، إلا أنه أعطى للقضية الكردية بعدًا دوليًا جديدًا ضمن صراع القوى العظمى حيث “غرّدت روسيا خارج سرب النداءات الإقليمية والدولية المحذرة لإقليم كردستان العراق من تبعات الاستفتاء والمطالِبة بتأجيله أو إلغائه، وشكّل الموقف الروسي استثناء واضحا في ثباته خلال ما قبل وبعد الاستفتاء”. (إلياس، 2017).
موقف إسرائيل: “إسرائيل وحدها هي التي دعمت التطلعات الاستقلالية للأكراد العراقيين. وذلك جزئيا لتخمينات استراتيجية، كما قالت الخبيرة الإسرائيلية للشؤون الكردية أوفرا بينغيو التي أوضحت أن ذلك يعود لأسباب أخلاقية بوجه خاص”. (دوتش فيلي DW، 2017).
ختاماً:
استفتاء كردستان 2017 لم يكن نهاية المطاف، بل كان محطة فارقة في المسيرة الطويلة للشعب الكردي نحو تحقيق حلمه بالدولة لقد أثبت أن الحقوق لا توهب، بل تنتزع، وأن الطريق إلى الحركة محفوف بالتحديات الخارجية، والداخلية على حد سواء الفشل في تحقيق الاستقلال الفوري لا يقلل من قيمة الإرادة الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع لقد زرع الاستفتاء بذرة لن تنمحي، وسيظل ذكراه حاضرة في الضمير الكردي كشهادة على أن هذا الشعب، رغم كل محن التاريخ، لم، ولن يتخلى عن حقه المشروع في تقرير مصيره على أرضه القضية الكردية بعد الاستفتاء لم تعد قضية مظلومية فحسب، بل أصبحت قضية سياسية بامتياز، تنتظر لحظتها التاريخية في ظل تحولات إقليمية ودولية قد تأتي بما لا تتوقعه الحسابات الآنية.
المراجع
Natali, D. (2017, September 26). The Kurdish Referendum: High Risks, Higher Stakes. World Politics Review.
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/23169/the-kurdish-referendum-high-risks-higher-stakes
International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). United Nations
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. (1960). United Nations.
Gunter, M. M. (2018). The Kurdish Referendum for Independence: A Political Analysis. Middle East Policy, 25(1), 79-89.
الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة: وديان جبل شقلاوة وراوندوز، 15 أيار (مايو) – 26 آب (أغسطس) 1988. (1992). موقع Human Rights Watch، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ANFAL7.htm
معركة سنجار: “تحرير” البلدة من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. (2015، نوفمبر 13). موقع BBC NEWSعربي، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/11/151113_kurds_sinjar_entrance_all_directions
العلي، عباس علي. (2019، نوفمبر 14). في نقد الدستور العراقي (مواد دستورية معطلة)، موقع الحوار المتمدن، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=655739
إلياس، سامر. (2017، سبتمبر 30). الورقة الكردية في حسابات موسكو الإستراتيجية، موقع الجزيرة نت، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.aljazeera.net/opinions/2017/9/30/الورقة-الكردية-في-حسابات-موسكو
كردستان العراق ـ مأزق الاستفتاء والحسابات الخاطئة. (2017، نوفمبر 24). موقع دوتش فيليDW الألمانية، تم الاسترجاع من الرابط التالي: