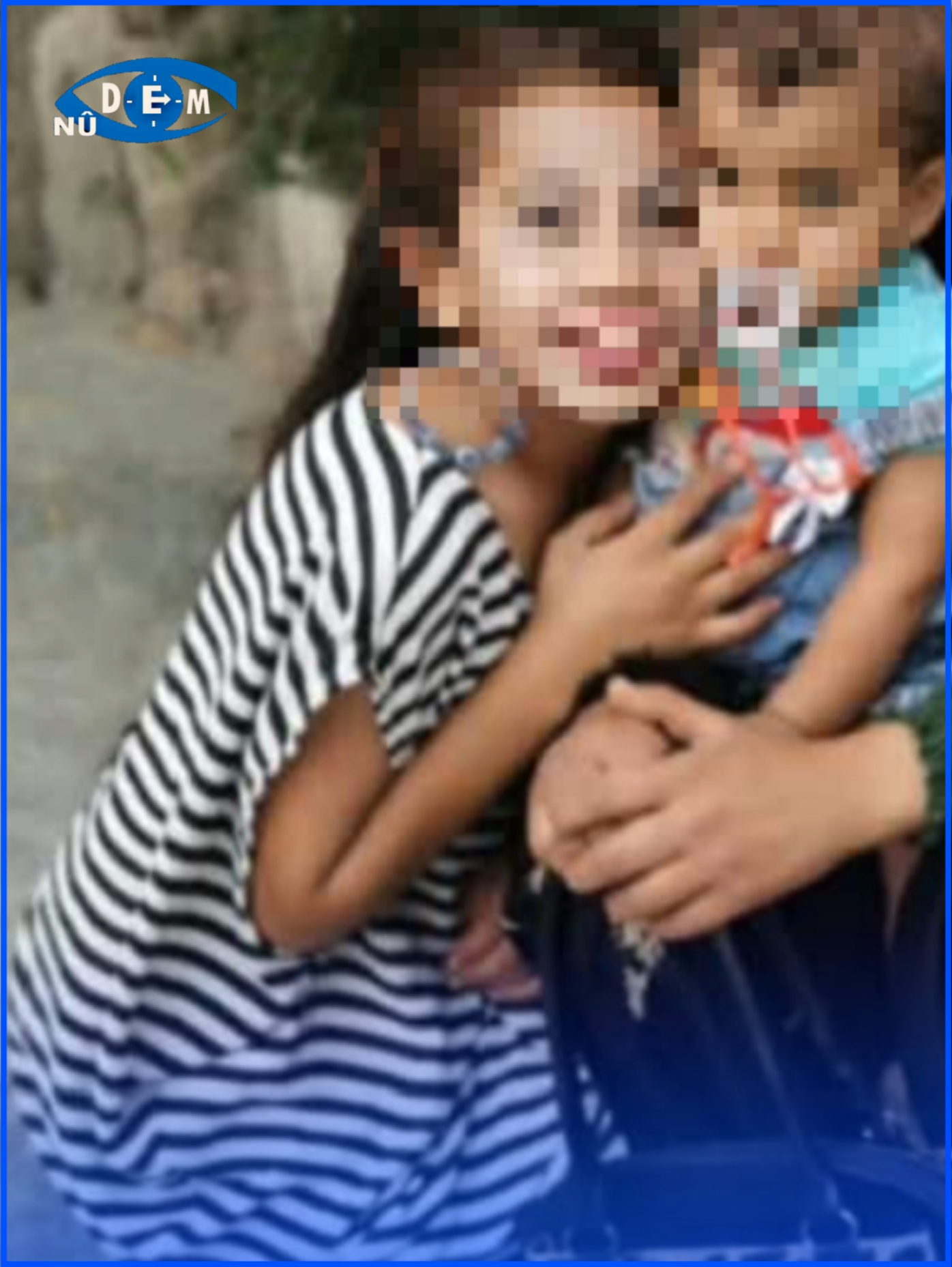بقلم: الدكتور مسعود حامد
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة Nûdem الإعلامية

منذ سنوات، لم يتوقف أبو محمد الجولاني عن محاولة إعادة صياغة صورته، ليس أمام القوى الدولية فحسب، بل حتى أمام السوريين الذين عاشوا آثار تحوّلاته المتناقضة منذ ظهوره الأول. فالرجل الذي بدأ مسيرته على رأس تشكيل عسكري ذي خلفية عقائدية متشددة، يحاول اليوم أن يرتدي ثوب “رجل الدولة”، وأن يظهر كصاحب مشروع سياسي قادر على قيادة مرحلة انتقالية في سوريا. ومع زيارة واشنطن التي أثارت جدلاً واسعاً، عاد السؤال القديم-الجديد: هل يمتلك الجولاني فعلاً مشروعاً وطنياً؟ أم أنه يسعى فقط لإعادة تموضع تكتيكي يضمن بقاءه لاعباً أساسياً في مشهد مضطرب؟
الحقيقة أن المتابع لتجربة الجولاني يدرك سريعاً أن ما يجري ليس مشروعاً وطنياً بقدر ما هو بحث عن شرعية خارجية، تُعوّض غياب الشرعية الداخلية. فزيارة واشنطن لم تُنتج مكاسب حقيقية للسوريين، ولم تحمل أي انعطاف سياسي يُخفّف من معاناتهم، بقدر ما بدت محاولة لإرضاء القوى العظمى ولو على حساب أولويات الشعب وحقوقه الأساسية. وبالرغم من الضجيج الإعلامي حولها، بقيت الزيارة في جوهرها خطوة شكلية، لا تغيّر في الواقع شيئاً، ولا تمنح الجولاني ما يفتقده منذ البداية: الثقة الشعبية.
الشرعية لا تأتي من الخارج
من يريد قيادة مرحلة انتقالية في بلدٍ كُسرت فيه كل الركائز، لا يمكنه تجاهل حقيقةٍ بسيطة:
لا وجود لقائد بلا شعب، ولا لشخصية وطنية بلا مشروع جامع.
بدلاً من التوجّه إلى الداخل السوري، وإطلاق مبادرة سياسية تتجاوز الانقسامات الحادة، انشغل الجولاني بإعادة تقديم نفسه للقوى الدولية، وكأنه يبحث عن ختم موافقة من الخارج قبل أن يسأل السوريين أنفسهم: هل يريدونه؟ هل يمثلهم؟ هل يشعرون أنه يدافع عن مصالحهم حقاً؟
هذه الأسئلة غير مطروحة عند الجولاني، لأنه يعرف أجوبتها مسبقاً. فأي خطاب وطني شامل لم يصدر عنه، وأي مشروع سياسي يعتمد على قبول كل المكونات السورية لم يقترب منه، بل على العكس، كان خطابه في كثير من الأحيان إقصائياً، موجهاً نحو فرض نموذج حكم ضيق لا يتسع إلا للموالين له.
كان يمكن أن تكون هناك فرصة… لكنه اختار الطريق الخطأ
لو أراد الجولاني فعلاً أن يحظى بقبول وطني، لكان الطريق واضحاً:
• الاعتراف بأن جميع السوريين ضحايا، وليس فصيلاً واحداً ولا منطقة واحدة.
• فتح باب شراكة حقيقية مع الكرد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
• التواصل مع السويداء ومع المكوّن العلوي بصفتهما جزءاً لا يتجزأ من مستقبل سوريا.
• طرح رؤية لا تُقسّم ولا تُقصي، وتتعامل مع السوريين باعتبارهم شعباً واحداً لا جماعات متنافرة.
هذه الخطوات وحدها كانت كفيلة بتغيير موقعه في الداخل، وربما منحه قوة سياسية تُحسب له، لكنها كانت تتطلب شجاعة الاعتراف بالآخر، والتخلي عن العقلية الأمنية الضيقة التي أدارت مناطق نفوذه خلال السنوات الماضية.
إلا أن الجولاني اختار المسار المعاكس: مسار فرض السيطرة بالقوة، وشنّ الحملات العسكرية ضد المدن والبلدات التي لم تخضع لسلطته، الأمر الذي رسّخ الانقسام بدل أن يخفّف منه، وعمّق الهوة بينه وبين شرائح واسعة من المجتمع السوري.
بين مشروع الدولة وممارسات السلطة
يطرح الجولاني نفسه اليوم كـ”رئيس سوري للمرحلة الانتقالية”، لكن هذا الادعاء يصطدم بواقع لا يمكن تجاهله:
ممارساته على الأرض لا تشبه ممارسات أي قائد حقيقي يسعى لبناء دولة.
فالدولة تُبنى على القانون، لا على الفصائل.
وتُبنى على الثقة، لا على الخشية.
وتُبنى على قبولٍ شعبي واسع، لا على هيمنة طرف واحد مهما كانت قوته.
لا يمكن لمن يريد الاعتراف الدولي أن يفرض على الداخل نمطاً من الحكم القائم على احتكار القرار السياسي والإداري والعسكري. ولا يمكن لمن يحلم بمقعد في مستقبل سوريا أن يتجاهل حقيقة أن القسم الأكبر من السوريين لا يرى فيه نموذجاً وطنياً، بل طرفاً آخر في معادلة صراع اتسعت على حساب الدم والخراب.
غياب الرؤية الوطنية الجامعة
ما ينقص الجولاني ليس العلاقات الدولية—بل الرؤية.
الرؤية التي تجمع السوريين لا التي تشتتهم.
الرؤية التي تبني مستقبلاً لا التي تستنسخ تجارب الإقصاء السابقة.
إن مشروعه، كما يظهر حتى الآن، ليس سوى محاولة للتمسك بدور سياسي في مشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات مجهولة. لكنه دور لا يرتكز على قاعدة وطنية حقيقية، ولا على مصالحة مع المكونات السورية المختلفة، ولا على اعتراف بالحقوق التاريخية والسياسية والثقافية التي يطالب بها الكرد والمكوّنات الأخرى.
خاتمة: من يريد قيادة سوريا يجب أن يمثلها
في بلدٍ مثخّن بالجراح، يحتاج السوريون إلى قيادة تحمل مشروع سلام وعدالة، لا مشروع سيطرة.
إلى رؤية توحّدهم، لا خطاب يعمّق الشقاق.
إلى قائدٍ يستمد قوته من الناس، لا من دعمٍ خارجي مؤقت سرعان ما يتبخر عند أول اختبار.
زيارة الجولاني إلى واشنطن قد تمنحه بعض الزخم الإعلامي، لكنها لا تكفي لكي يصبح ممثلاً لسوريا، ولا لتغيير حقيقة أن مشروعه—حتى الآن—أضيق بكثير من وطنٍ اسمه سوريا، وأكثر هشاشة من أن يكون جسراً نحو المستقبل